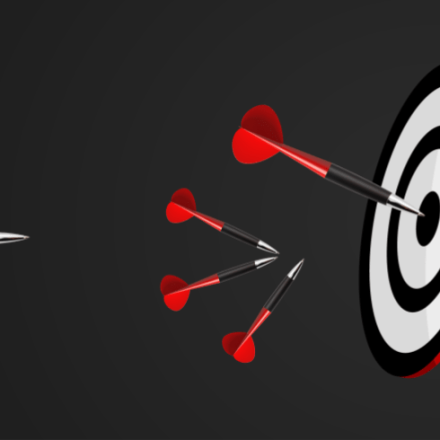هرب بشار الأسد من دمشق في 8 كانون الأول 2024، وانسحبت الأفرع الأمنية وعساكر جيشه من المدن، في حين دخلت فصائل غرفة عمليات الجنوب إلى العاصمة، ودخلت لاحقاً إدارة العمليات العسكرية، وبدأت محاولات ضبط المدينة وتأمين الخدمات فيها، وتسارعت الأحداث مابين اختفاء ضباط أمن النظام والقبول برئيس وزراء نظام الأسد الهارب محمد غازي جلالي لتسيير الأعمال، وانتشار بعض عمليات التخريب في الممتلكات الحكومية قبل دخول إدارة العمليات العسكرية، وظهور رواية وجود سراديب مخفية في سجن صيدنايا تُخفي آلافاً من المغيبين قسرياً خلال سني الثورة، وكل ذلك تزامن مع تحول عدد كبير من الذين شاركوا ككيانات أو أشخاص في التحريض على قتل السوريين أو حتى قتلهم إلى تأييد الثورة، ظهر سؤال في ذهن كل سوري شارك بهتاف أو فكرة أو كلمة ضد نظام الأسد أو حتى تم تهجيره من بيته، هل نجحت الثورة ؟
ثورة لكل السوريين ولكن!!
يحمل كل شخص في أي دولة سواء كانت ديمقراطية أو يحكمها نظام مستبد؛ واجبين تجاه باقي أفراد المجتمع، أولها واجب أخلاقي ألا يرضى لهم أن تتعرض حرياتهم الفردية لأي انتهاك، وواجب وطني للدفاع عن من يتعرض لظلم أو انتهاك عبر مناصرته والوقوف معه، ولكن في الدول الاستبدادية يُضاف حاجز قد يغطي هذين الواجبين وهو حاجز الخوف الذي يمنع الشخص من التعبير عن رفضه لسلوك النظام الحاكم، ولكن يرافق هذا الخوف غضب ضمني وعدم رضى عن سلوك هذا النظام، وفي تجارب الثورات كان دائماً ما يصطف أجزاء من الشعب مع النظام الحاكم ملكياً كانت طبيعته أو جمهورياً، ولكن أن يطالب المصطفون إلى جانب نظام بإبادة مدن كاملة، فهذا لم يحدث إلا مع بعض مؤيدي نظام الأسد عندما طالبوا بإبادة ادلب وأرياف حلب فقط لأنها حُررت من سلطة الأسد.
ومع أن هؤلاء الحالمين الذين خرجوا في آذار 2011 مطالبين بسوريا حرة أكدوا أنها ثورة لكل السوريين، ولكن أصر سوريون آخرون أن لا تكون هذه الثورة لهم، بل أن يقفوا مع الجلاد وأن يكونوا سوطه الذي يضرب به وصوته الذي يهين المتظاهرين من خلاله، ويده التي تُزين وجه الأسد “مدنياً” وفنياً وحتى دينياً، ومع هروب الأسد ورميه لسوطه ونكرانه لصوته وقطعه ليده، وجد المؤيدون أنفسهم مرميين بين ثِقل إرث الأسد الذي أثقلهم به وبين آلاف الناس العائدين إلى مدنهم التي هجرهم الأسد منها، أو في وجه أمهات يبحثن عن ورقة تُثبت أن الأسد قد منح أبناءهم الحياة بعد أن غيبهم لسنوات، فكان الحل الأسرع لهؤلاء المؤيدين أن يغيروا أصواتهم ويلتحقوا بالثورة التي انتصرت على قائدهم الذين صدقوا سابقاً أنه بالفعل إلى الأبد!!! ولكن خدعهم فسقط.
الواجهات “المدنية” التي استعان بها نظام الأسد لخرق العقوبات وتسويق مناطقه على أنها مناطق نشطة “مدنية” لجلب المساعدات الدولية لتعزيز سلطته الأمنية على المجتمع وخرق العزلة الدولية المفروضة عليه.
ولا بد من التمييز بين أنواع من كانوا مع الأسد في سنوات الثورة:
– منهم من أيد الأسد بسب روايات النظام عن سوء البديل القادم، وأن الأسد وأذنابه هم الضامن لاستقرار هذه البلاد التي تقبع عاصمتها على مدينة من السجون من أبناء تلك البلاد، ولكن لم يَسعَ هؤلاء إلى قتل باقي السوريين ولم يسهموا في ذلك بل اكتفوا بالتنازل عن واجباتهم الأخلاقية والوطنية في سبيل النجاة الفردية، التي ظنوا أنها ستحميهم وستجعل الأسد وفياً لهم ليُصعِدَهم إلى سفينته إن جاء الطوفان يوماً، فهؤلاء وطنياً لا يمكن المساس بهم، ولكن بالتأكيد أنهم سقطوا في الاختبار الأخلاقي سابقاً، وقد يُكفِّرون اجتماعياً عن ذلك بمساعدتهم في كشف جرائم الأسد، وأن يُقدموا خدمات ومساهمات لجبر ضرر (أي تقديم مساعدات نفسية واجتماعية ومادية) للمعتقلين المفرج عنهم أو عائلات الذين قُتلوا قصفاً أو خنقاً أو تعذيباً.
– منهم من كان ضمن منظومة الأسد الأمنية والعسكرية، هؤلاء من الواجب أن يمروا بثلاث مراحل أولها الاعتقال وثانيها المحاسبة، وثالثها فرض جبر الضرر للمعتقلين وأهاليهم.
– الواجهات “المدنية” التي استعان بها نظام الأسد لخرق العقوبات وتسويق مناطقه على أنها مناطق نشطة “مدنية” لجلب المساعدات الدولية لتعزيز سلطته الأمنية على المجتمع وخرق العزلة الدولية المفروضة عليه، واستغلال الأزمات التي مرت ابتداء من جائحة كورونا مروراً بكارثة الزلزال وأخيرا القادمون اللبنانيون إلى مناطق سيطرة الأسد، وتشمل تلك الواجهات: الوجوه الدينية والنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات، حيث من الواجب إيقاف عملها وتشكيل نقابات حرة أخرى بعيدة عن العمل “المدني” الذي جعله الأسد أداة له قانونياً وأمنياً.
يجب أن يترافق مع الثورة الاستفادة من تجارب السوريين الذين شكلوا عملاً جباراً بعد ثورة 2011 في الجعرافية السورية المحررة أو المغترب.
المجتمع المدني السوري بعد سقوط الأسد
من المفترض أن تكون لحظة سقوط الأسد هي لحظة انهيار منظومة كاملة وليس هروب أسرة حاكمة وحسب، بل تشمل المنظومة كاملة، ويجب اصلاحها ابتداء من الجيش والأمن مروراً بالعمل النقابي والاقتصادي، إذ لا يعني انتصار الثورة أن تستمر المنظومة نفسها وتُغيّر لون العلم فقط، أو انتقال الكيانات نفسها من عبارة “الله سوريا بشار وبس” إلى “سوريا حرة، إذ لا يمكن لكيان من المفترض أن يُمثل الطلاب أن تُمحى جرائمه بحق الطلاب أنفسهم بمجرد أن يغير شعاره وصورته مثل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، أو مجموعة تجار شكلوا عصباً للنظام مثل “غرف التجارة” أن تغسل تاريخها ببيانات وتغيير ألوان علمها من أحمر لأخضر، أو حتى لدكاترة جامعات كانت لهم مهام أمنية ضد زملائهم وطلابهم، أو حتى منظمات تدعي المدنية ولكنها كانت لحزب البعث وجيش الأسد رديفاً وداعماً اجتماعياً واقتصادياً أن تحافظ على هيكلتها وتستمر بعملها بنفس الديناميكيات ولكن مع تغيير الشعارات.
يجب أن يترافق مع الثورة الاستفادة من تجارب السوريين الذين شكلوا عملاً جباراً بعد ثورة 2011 في الجعرافية السورية المحررة أو المغترب، إذ لم يكونوا فقط مؤسسات أو جمعيات مدنية، بل استطاعوا أن يعوضوا غياب الدولة القوية التي تفتح الطرقات وتبني المدارس وتستجيب للكوارث، فكانت المؤسسات هي الحامل الأساسي للشعب والمجتمع بالتزامن مع حكومات متعدد تؤدي جزءا من دورها المفترض، ويُضاف أن وظيفة الثورة المنتصرة هي أن تُعيد فكرة إحياء المجتمع المدني، التي تتجلى وظيفته بتمثيل المجتمع وعكس مطالبه والدفاع عن حقوقه تجاه الدولة، لا أن يكون رديفاً للدولة ضد المجتمع، وبالتالي في سوريا الحالية وسوريا المستقبل يجب أن تكون كيانات الأسد “المدنية” من الماضي ويعاد هيكلتها بشكل كامل قانونياً بالدرجة الأولى، ويتبعها عمليات ديمقراطية تتم داخلها لتمثيل الشرائح، فاتحاد الطلبة هو المنادي بحقوق الطلبة لا مكرراً لرواية السلطة ضد الطلبة، ونقابة المحامين هي من تدافع عن المحامين لا عن قوانين الدولة فقط.
ختاماً؛ لقد نجحت الثورة بخلع الأسد واستكمال نجاحها مرتبط بإعادة هيكلية سوريا الحرة، التي تصنع مجتمعاً مدنياً متماسكاً بعيداً عن السلطة الأمنية والعسكرية، وتحاسب الذين تورطوا في قتل الشعب وتعذيبه، فمن قتل مئات آلاف السوريين ليسوا فئة قليلة بل كانوا ضمن سلسلة مُنَظَمة، تبدأ من ملاحقة الناس وتقصي أخبارهم ثم اعتقالهم ثم تعذيبهم لسنوات ثم قتلهم ثم دفنهم ثم إخفاء آثارهم ويضاف إليها ابتزاز أهالي المعتقلين في معظم الأحيان، ولن يكون هناك سوريا لجميع السوريين إن لم يحاسب منتهكو كل هذه الجرائم من قِبل الدولة، ويجب ألا تُغفر لهم جرائهم بمجرد أنهم يرددون شعارات وردية بعد هروب سيدهم، أو حتى بسبب تحول شعاراتهم التقديسية من شخص لشخص، لأن الدولة التي لا تحاسب عن دماء الشعب، تفتح الباب لدماء جديدة ستسيل في المستقبل، لأن المجرم الذي رضي أن يعذب شعبه سيبقى سلوكه ثابتاً وسيكرره في أي لحظة إن لم يحاسب على كل مافعل.